شهدت بريطانيا في أواخر القرن السابع عشر ولادة ظاهرة جديدة غيّرت وجهها السياسي والاجتماعي إلى الأبد، هي ظاهرة الحزبية السياسية. في هذا الكتاب، يقدم المؤرخ والكاتب البريطاني جورج أويرز عملاً بحثياً يتتبع فيه جذور الانقسام السياسي بين فئتين شكلتا أساس الحياة السياسية الحديثة في البلاد.
يشير عنوان الكتاب «غضب الحزبية: كيف صنع صراع الويغ والتوري بريطانيا الحديثة» إلى حالة الاحتدام والانقسام التي عمّت بريطانيا في تلك المرحلة، حين تحوّلت الخلافات الفكرية والدينية إلى صراع مفتوح بين معسكرين، يهدد أحياناً بانفجار اجتماعي وسياسي واسع. يشرح الكتاب مصطلحي الويغ والتوري اللذين شكّلا أول تعبير عن الانقسام الحزبي في التاريخ البريطاني. ظهر اسم الويغ في الأصل كلقبٍ ساخر أُطلق على معارضي الملكية المطلقة، وكان يشير إلى جماعات رعاة الماشية في اسكتلندا الذين اتُّهموا بالعصيان، ثم تبنّاه أنصار البرلمان والإصلاح السياسي كتعبير عن رفضهم لتغوّل السلطة الملكية. أما التوري، فكان في بدايته وصفاً ازدرائياً لمؤيدي الملك والكنيسة، مأخوذاً من كلمة إيرلندية تعني «اللص» أو «المتمرد في الجبال»، ثم تحوّل إلى اسم لحزبٍ محافظ يدافع عن النظام التقليدي والتراتبية الاجتماعية. ومع مرور الوقت، غدت الويغ رمزاً للتيار الليبرالي الإصلاحي، في حين مثّل التوري الاتجاه المحافظ الذي يركز على الاستقرار والمؤسسات.
جذور الانقسام
يُظهر فهرس الكتاب أن المؤلف بنى عمله في ثلاثة عشر فصلاً مترابطاً، تتدرج من النشأة الأولى للحزبية البريطانية إلى ذروتها في عهد الملكة آن. يبدأ السرد بفصول تمهيدية تحمل عناوين مثل «ميلاد الويغ والتوري» و«الثورة وعودة الويغ»، حيث يوضح أويرز كيف ظهرت الانقسامات بين المعسكرين نتيجة الصراع الديني والسياسي، ثم كيف استعاد حزب الويغ نفوذه بعد «الثورة المجيدة» عام 1688. في هذه المرحلة يسلّط الضوء على إعادة تشكيل التحالفات السياسية وصعود القوى الاقتصادية الجديدة التي ستصبح فيما بعد حجر الأساس للرأسمالية البريطانية الحديثة.
في الفصول اللاحقة، يتعمّق المؤلف في تحليل المراحل الحاسمة من المواجهة بين الحزبين، مثل المعارك الانتخابية الدامية، ودور رجال الدين والسياسيين في تأجيج الانقسام، وصولاً إلى ما يسميه «نهاية التوري» التي تمثل انهيار المعسكر المحافظ في مطلع القرن الثامن عشر. كما يتناول أثر شخصيات محورية مثل هارلي وساتشيفريل، الذين لعبوا أدواراً متناقضة بين السياسة والدين والدعاية الشعبية. ومن خلال تتبع هذه الوقائع، يربط أويرز بين التاريخ السياسي والوعي الجمعي للأمة، مبرزاً كيف أن ما بدأ كصراع على العرش تحول إلى تأسيس دائم لثقافة الحزبية التي لا تزال تشكل جوهر الحياة السياسية البريطانية حتى اليوم.
ينطلق المؤلف من لحظة حاسمة في التاريخ البريطاني، حين ثار الجدل حول خلافة الملك تشارلز الثاني، وما إذا كان من الممكن السماح لملك كاثوليكي، جيمس الثاني، باعتلاء العرش. من هذه الأزمة وُلد أول انقسام سياسي واضح بين فريقين متعارضين: فريق يدافع عن سلطة البرلمان وعن الفكر البروتستانتي المعارض للكاثوليكية، وفريق آخر يمثل القوى التقليدية المتمسكة بالملكية والكنيسة. كان ذلك صراعاً على الحكم وولادةً لثقافة سياسية جديدة أثّرت في مسار بريطانيا لقرون طويلة، وجعلت الانقسامات الفكرية والدينية تشكل ملامح الدولة الحديثة.
يستعرض الكتاب بأسلوب شيّق مراحل تطور هذا الصراع، من حروب المنشورات التي ملأت الشوارع بالاتهامات، إلى الانتخابات المشوبة بالفساد والعنف، وصولاً إلى الثورات والمؤامرات ومحاولات الاغتيال. يرسم المؤلف لوحة مليئة بالشخصيات المتناقضة: رجال دين متحايلون، وساسة طموحون، ومغامرون لم يترددوا في إشعال الفتن لتحقيق مكاسب شخصية. ومع مرور الزمن، تجاوز الخلاف السياسة ليصبح صراعاً ثقافياً واجتماعياً، يعكس رؤيتين متعارضتين للعالم: رؤية محافظة تدافع عن النظام والتراتبية، وأخرى إصلاحية تميل إلى الحرية الاقتصادية والدينية. من رحم هذا التناقض، كما يوضح أويرز، نشأت مؤسسات كبرى مثل بنك إنجلترا والاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا، وتمهّد الطريق لاحقاً لظهور الإمبراطورية البريطانية.
بين الصراع على العرش وتأسيس الدولة الحديثة
يقول المؤلف في مقدمته: «في اليوم الذي أُعلن فيه عن الانتخابات العامة لعام 2017 في بريطانيا، قالت سيدة تُدعى بريندا، من مدينة بريستول، جملةً لخّصت مشاعر كثير من الناخبين المتعبين من السياسة: «هل تمزحون؟ انتخابات أخرى؟ بحقّ الله، لا أستطيع، حقاً لا أستطيع تحمّل هذا... هناك قدرٌ مفرط من السياسة هذه الأيام».
ويعلّق المؤلف بأن بريندا يجب أن تكون ممتنّة لأنها لم تعش في زمن الملكين وليم الثالث والملكة آن؛ ففي الفترة بين عامي 1695 و1715 شهدت إنجلترا عشرة انتخابات عامة، وكانت الحزبية السياسية تمسك بخناق البلاد على نحوٍ نادر في شدّته وطوله. في تلك الحقبة انخرط الحزبان الرئيسيان، التوري والويغ، في معركة سياسية شرسة ومستهلكة لكل شيء، حول قضايا الدين وخلافة العرش والسياسة الخارجية والاقتصاد والتمويل، إلى جانب ملفاتٍ أخرى لا تقلّ أهمية.
ويضيف الكاتب أن تلك المرحلة كانت، من منظورٍ لاحق، أشبه بآخر نفسٍ لصراعٍ سياسيّ مدمرٍ كان قد خيّم على البلاد منذ أربعينيات القرن السابع عشر. فكل الخصومات القديمة التي عرفتها الحرب الأهلية بين أنصار الملكية (الفرسان) وأنصار البرلمان (البيوريتانيين) عادت إلى الحياة من جديد، ولكن في شكل حزبي جديد. ورغم أن هذه المواجهة كانت صاخبة، مثيرة للاستقطاب، وأحياناً عنيفة، فإنها سمحت لبريطانيا بأن تتجاوز فترة مضطربة من دون الانزلاق إلى حرب أهلية أخرى أو إراقة دماء واسعة.
ثم ينتقل المؤلف ليشرح أن هذا الصراع السياسي – المعروف تاريخياً باسم «غضب الحزبية» – كان استثنائياً من حيث شدّته وطوله. ففي أعلى دوائر السلطة، كان مسرحاً للفساد والخيانة ومحاولات الاغتيال والعلاقات غير المشروعة، ولأبشع المناورات البرلمانية الماكرة، وحتى لاتهامات علنية بالشذوذ طالت بعض السياسيين. تسلّل هذا الصراع إلى كل زاوية من الحياة العامة البريطانية، من وصيفة الملكة إلى مجلس العموم، ومن المجالس الملكية إلى المقاهي الشعبية التي كان الناس يتجادلون فيها حول الأحداث.
ويضيف الكاتب: «وفي صيف عام 1709 وصلت إلى لندن آلاف من اللاجئين المرهقين والمصدومين نفسياً، جاؤوا من منطقة تدعى بالاتينات في ألمانيا، بعد أن دمّرها الجيش الفرنسي بقيادة لويس الرابع عشر، وتفاقم دمارها نتيجة الحروب الأوروبية المتتالية. كان الجوع والمرض قد أنهكهم إلى حدّ اليأس، وبحلول وصولهم إلى إنجلترا كانوا في حالة مأساوية. سجّل بعض القساوسة اللوثريين الذين اعتنوا بهم أن بين عشرين وثلاثين رجلاً وامرأة وطفلاً كانوا يعيشون معاً في غرفة واحدة، وكثير منهم كانوا ضعفاء جداً ومرضى حتى إن بعضهم مات قبل أن يُقدَّم له أي عون. كان أمل هؤلاء اللاجئين أن يجدوا في إنجلترا، أو لاحقاً في المستعمرات الأمريكية، خلاصهم. ولحسن حظهم، كان الحكم في ذلك الوقت بيد حزب الويغ، الذي تعاطف مع محنتهم. لم يرَ قادة الويغ في مساعدتهم مجرد واجبٍ إنساني مسيحي تجاه الغريب، بل نظروا إليهم أيضاً كبروتستانت شجعان يستحقون الدعم من إخوتهم في الإيمان الأوروبيين. كما أمل الويغ أن يشكّل هؤلاء اللاجئون إضافة اقتصادية للمجتمع البريطاني».
في ختام الكتاب، يبرز المؤلف كيف أن هذا الغضب الحزبي، على الرغم من خطورته، كان عاملاً أساسياً في تطور الفكر الديمقراطي البريطاني. فقد جعل من الجدل والاختلاف وسيلة لبناء الوعي السياسي، حتى إن أدى أحياناً إلى الانقسام والاضطراب. وهكذا يتحول الكتاب إلى تأمل عميق في طبيعة السياسة نفسها، وفي الثمن الذي تدفعه الأمم حين تتحول النقاشات الفكرية إلى معارك من أجل السيطرة والنفوذ.











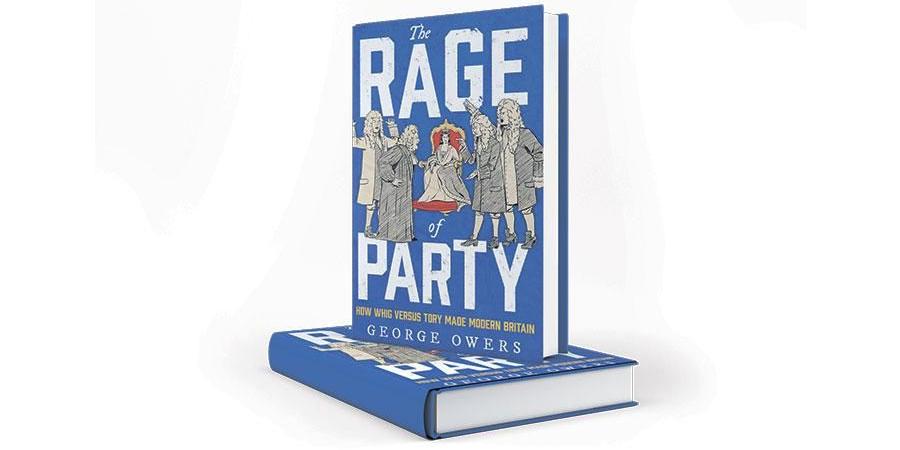







0 تعليق